عصر رأس المال (1875-1848).. إيريك هوبزباوم /تقديم كتاب/
في كتابه عصر الثورة عرض هوبزباوم تحولات الحياة الأوروبية بين عامي 1789 و1848. إلا أن نيران الثورة خبت في الأعوام اللاحقة وحل محلها نظام جديد من القيم والمعايير والخلقيات صنعت كلها معاً ما أسماه «عصر رأس المال».
في عصر رأس المال (1848 – 1875) يواصل هوبزباوم تحليله الثاقب والعميق لصعود الرأسمالية الصناعية ولترسخ الثقافة البورجوازية. إن امتداد الاقتصاد الرأسمالي وتوسعه ليشمل كل بقاع الأرض، وكذلك تمركز الثروة، والهجرات البشرية، وسيطرة أوروبا وثقافتها، قد جعلت من الفترة المذكورة حداً فاصلاً، لا في تاريخ أوروبا فحسب، بل في تاريخ العالم.
ويربط هوبزباوم الاقتصاد بالتطورات السياسية والفكرية ليعطينا تاريخاً واقعياً عن الثورة وعن فشلها، وعن الاقتصاد الرأسمالي ودوراته، وعن انتصارات القيم البورجوازية وضحاياها.
المقدمة
في ستينيات القرن التاسع عشر، دخلت القاموس الاقتصادي والسياسي كلمة جديدة : «الرأسمالية»(1) (Capitalism). من هنا، يبدو مستغرباً أن تعطي هذا الكتاب عنوان رأس المال الذي يذكرنا بالعمل الرئيسي لناقد الرأسمالية الأشد قسوة، وهو كارل ماركس في مؤلفه المعروف رأس المال (Das Kapital) (1867) الذي نـشـر خـلال تـلك الفترة، ذلك أن انتصار الرأسمالية عالمياً أصبح هو موضوع التاريخ الأساسي في العقود التي تلت عام 1848، وكان انتصاراً لمجتمع يعتقد أن التوسع الاقتصادي يكمن في المشروع الاقتصادي التنافسي الخاص، وفي النجاح بابتياع أي شيء في أرخص سوق (بما في ذلك العمل)، ثم بيعه بالسعر الأعلى. وكان يعتقد أن اقتصاداً كهذا، قائماً على هذه الأسس، ومرتكزاً بالطبع على قواعد راسخة . البورجوازيين الذين يجمعون بين النشاط، والجدارة، والذكاء، لن يقتصر على خلق عالم تتوزع فيه الوفرة المادية فحسب، بل سيولد حركة متزايدة للتنوير ،
والتفكير العقلي، والفرص الإنسانية، وازدهاراً في العلوم والآداب ؛ أي، باختصار، عالماً يتصف بالتقدم المادي والأخلاقي المتسارع المطرد. وسيصار إلى إزالة البقية الباقية من العوائق التي تقف حجر عثرة في سبيل التنمية السلسة للمشروع الخاص. وستتطور المؤسسات في العالم، بل في بقاع العالم التي لم تكبلها التقاليد والخرافات، أو تلك التي شاء حظها العاثر أن لا يكون أهلها من ذوي البشرة البيضاء (وتحديداً من منطقة أواسط أوروبا وشمال غربها)، وستتحول هذه المؤسسات إلى ما يماثل النموذج العالمي لأمة/ دولة تقوم على مساحة محددة من الأرض . وسيكون لها دستور يضمن حق الملكية والحقوق المدنية، ومجالس تمثيلية منتخبة تخضع الحكومات للمساءلة أمامها، وستمارس فيها، حيثما كان ذلك مناسباً، المشاركة السياسية من جانب عامة الناس، ولكن في الحدود التي تضمن استمرار النظام الاجتماعي البورجوازي وتحول دون تقويضه. إن هذا الكتاب لا يهدف إلى تقصي المراحل الأولى لنشوء هذا المجتمع، ويكفي في هذا المقام أن نتذكر أن هذا المجتمع حقق اختراقه التاريخي، إذا جاز التعبير، على الجبهات الاقتصادية والسياسية الأيديولوجية في العقود الستة التي سبقت عام 1848. لقد هيمنت على الفترة الممتدة بين الأعوام 1789 و1848 ثورة مزدوجة (وقد ناقشت ذلك في مؤلف سابق، (وسأحيل القارئ إلى ذلك الكتاب بين الفينة والفينة). وقد تمثل أحد جانبي هذه الثورة في التحولات الصناعية التي انطلقت بداياتها الرائدة في بريطانيا وظلت، على العموم، داخل حدودها. وتجسد الجانب الآخر في التحولات السياسية التي ارتبطت بفرنسا، وظلت أيضاً على الـعـمـوم داخل حدودها. وكانت هذه التحولات انتصاراً لمجتمع جديد، إلا أن تحول هذا المجتمع إلى انتصار للرأسمالية الليبرالية، أو ما دعاه أحد المؤرخين الفرنسيين «البورجوازية الظافرة» (The Conquering Bourgeois)، كان في نظر معاصري تلك الفترة أبعد احتمالاً مما هو في نظرنا اليوم. وخلف الدعاة السياسيين البورجوازيين، اصطفت الجماهير التي كانت قد عقدت العزم على تحويل الثورات الليبرالية المعتدلة إلى ثورات اجتماعية. وتحت قيادة طبقة أصحاب المشروعات الرأسمالية وحولهم، كانت جماهير «الكادحين الفقراء» الساخطة المهمشة تتململ وتتهيأ للانتفاض. وكانت الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر عقوداً مأزومة لم يستطع التكهن بنتائجها إلا المتفائلون.
على الرغم من ذلك، فإن ازدواجية الثورة الممتدة بين عام 1789 – 1848 تضفي على تاريخ تلك الفترة طابع الوحدة والتوازن. ومن السهل، على نحو ما، أن نكتب عنها ونقرأ عنها؛ لأن لها، على ما يبدو، موضوعاً واضحاً وشكلاً واضحاً، كما أن تخومها الزمنية محددة بوضوح ولا يحق لنا أن نتوقع أكثر منها في ما يتعلق بشؤون البشر، ففي ثورة 1848، التي نستهل بها هذا المجلد، انهار التوازن الذي شهدنا بداياته من قبل، كما تغير الشكل. وتقهقرت الثورة السياسية، وتقدمت الثورة الصناعية. لقد كانت سنة ألف وثمانمئة وثمان وأربعين، وهي «ربيع الشعوب الشهير» هي الثورة الأوروبية الأولى والأخيرة، بالمعنى الحرفي للكلمة (تقريباً)، وكانت التحقق المؤقت لأحلام اليسار، ولكوابيس اليمين، والإطاحة المتزامنة تقريباً بأنظمة الحكم القديمة في أغلب القارة الأوروبية غرب الإمبراطوريتين الروسية والتركية، من كوبنهاغن إلى باليرمو، ومن براسوف إلى برشلونة. كان ذلك متوقعاً، وقد سبق التكهن به. وبدا أن ذلك تتويج ونتيجة منطقية لحقبة الثورة الثنائية المزدوجة.
بيد أن تلك الثورة منيت بالفشل، بصورة كلية، وسريعة، وكذلك بصورة مؤكدة – مع أن اللاجئين السياسيين لم يدركوا ذلك لسنوات عدة. ولم يعد ثمة فرصة لقيام الثورة الاجتماعية الشاملة المأمولة قبل عام 1848 في دول العالم «المتقدمة». وعوضاً عن ذلك، قيض لمركز الثقل لهذه الحركات الاجتماعية الثورية، ومن ثم للأنظمة الاشتراكية والشيوعية في القرن العشرين، أن يكون في البقاع الهامشية المتخلفة، وذلك على الرغم من أن الحركات من هذا النوع كانت في الفترة التي يعالجها هذا الكتاب عرضية عتيقة «متدنية النمو». وقدم توسع الاقتصاد الرأسمالي العالمي المفاجئ، العريض الذي لا تحده حدود في الظاهر، بدائل في الأقطار «المتقدمة». لقد ابتلعت الثورة الصناعية (البريطانية) الثورة السياسية (الفرنسية).
من هنا، فإن تاريخ تلك الفترة مقلوب رأساً على عقب، فهو، أساساً، تاريخ التقدم الهائل للاقتصاد العالمي للرأسمالية الصناعية، والنظام الاجتماعي الذي يمثله، وللأفكار والمعتقدات التي ظهر أنها تشرعنة وتصادق عليه : فـي مـيـاديـن الـفـكـر، والعلم، والتقدم، والليبرالية. إنها حقبة البورجوازية الظافرة، مع أن البورجوازية الأوروبية ترددت في الالتزام بالحكم السياسي العام. وإلى هذا الحد، وربما إلى هذا الحد فحسب، فإن عصر الثورة لم يكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد، فقد ارتعبت الطبقات الوسطى في أوروبا، وظل يساورها الرعب من الشعب : إذ كان من المعتقد أن «الديمقراطية» ما هي إلا خطوة مؤكدة لـ «الاشتراكية» القادمة سريعاً لا محالة. وكان الرجال الذين أمسكوا بزمام الأمور رسمياً في النظام البورجوازي الظافر، في أزهى مراحل انتصاره، جماعة من نبلاء الأرياف الرجعيين في بروسيا، ونسخة مصطنعة مزيفة لإمبراطور في فرنسا، وسلسلة متعاقبة الملاك الأرستقراطيين في بريطانيا. وكان الخوف من الثورة حقيقياً، والشعور بعدم الأمان الذي أثارته عميقاً. وعند نهاية الفترة التي نعالجها، أسفر مثال واحد للثورة في دولة متقدمة، وهو انتفاضة قصيرة الأمد ومحلية تقريباً في باريس، عن وقوع حمام دم أعظم مما شهدته أحداث 1848 كلها، وأدى إلى موجة من المناوشات الدبلوماسية المتشنجة. لكن حكام الدول المتقدمة في أوروبا بدأوا بعد بعض التردد يوقنون في تلك الآونة أن «الديمقراطية»؛ أي البرلمان الدستوري الذي يعتمد على الاقتراع العريض، كان أمراً لا مناص منه، وأنه قد يكون أمراً مزعجاً، ولكنه لا يلحق الضرر من الوجهة السياسية. وكان حكام الولايات المتحدة قد أنجزوا هذا الاكتشاف منذ أمد بعيد.
إن السنين الممتدة بين عام 1848 وأواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر ليست، من ثم، من الفترات التي تلهب خيال القارئ الذي تستهويه المشاهد الدرامية والبطولية بالمعنى التقليدي للكلمة. ذلك أن حروب هذه الفترة ـ التي شهدت معارك حربية أكثر عدداً مما شهدته السنون الثلاثون السابقة، والسنون الأربعون اللاحقة، كانت إما عمليات قصيرة يحسمها التفوق التقاني والتنظيمي، مثل أكثر الحملات الأوروبية في ما وراء البحار، والمعارك السريعة الحاسمة التي قامت على أساسها الإمبراطورية الجرمانية بين عامي 1846 – 1871؛ أو مذابح اعتباطية لم تدع شرف ارتكابها حتى أكثر الأطراف المتحاربة وطنية، مثل حرب القرم بين عامي 1854 – 1856. وكانت أعظم الحروب في ذلك العهد، هي الحرب الأهلية الأمريكية، قد تكللت بالنصر في التحليل الأخير نظراً لثقل القدرة الاقتصادية والموارد المتفوقة. وكان للجنوب الخاسر جيش أفضل، وجنرالات أفضل. وقد برزت خلال تلك الفترة لحظات رومانطيقية. تجلت فيها، على ندرتها، مشاهد البطولة الباهرة ، ومنها صورة غاريبالدي (Garibaldi) بخصلات شعره المنسابة وقميصه الأحمر. كما لم تكن ثمة عناصر درامية في الحياة السياسية حيث حددت معايير النجاح، وفق تعريف والتر بيجهوت (Walter Bagehot)، بأنها حـيـازة «آراء عـاديـة، وقدرات غيـر عـاديـة». و كـان نـابـليون الثالث (Napoleon III) يحس بالضيق لدى ارتدائه معطف عمه العظيم نابليون الأول. كما كان لنكولن (Lincoln) وبسمارك (Bismarck) ، اللذان استفادت صورتهما العامة من تجاعيد الوجه وجمال الأسلوب النثري لدى كل منهما، رجلين عظيمين بالفعل، غير أن إنجازاتهما الفعلية كانت نتيجة مواهبهما بصفتهما سياسيين ودبلوماسيين، شأنهما شأن كافور في إيطاليا.
تجلت أكثر العناصـر الـدرامية في تلك الفترة في المجالين الاقتصادي والتقاني في: حديد يصب ويتدفق بملايين الأطنان إلى أرجاء العالم، ويتلوى في أشرطة من السكة الحديدية عبر القارة الأوروبية، والـكـوابـل الـتـي تمتد تحت الماء عبر المحيط الأطلسي، وحفر قناة السويس، وقيام مدن كبرى، مثل شيكاغو، تنبت في التربة العذراء في الغرب الأوسط الأمريكي، وموجات ضخمة من المهاجرين، لقد كانت هي دراما السطوة الأوروبية والأمريكية وقد جئا العالم عند أقدامها. غير أن الذين تولوا استغلال هذا العالم المقهور كانوا، عدا قلة قليلة من المغامرين والرواد في المناطق النائية، رجالاً رصينين، يرتدون ملابس وقورة، ويستدعون الاحترام في الوقت الذين يعرضون فيه مصانع إنتاج الغاز، وخطوط السكة الحديد، والقروض، مقرونة بمشاعر التفوق العرفي.
كانت هذه هي دراما التقدم، الكلمة المفتاح في ذلك العصر؛ التقدم الكاسح، المستنير، الواثق من نفسه، الراضي عن نفسه، وفوق هذا وذاك، الحتمي. ولم يكن بين ذوي السلطة والنفوذ، وفي أي موقع أو سياق في العالم الغربي من يستطيع حينئذ أن يصده أو يقف في وجهه. ولم يستطع غير قلة من المفكرين، وربما عدد أكبر من ذلك بقليل من النقاد المتبصرين أن يتنبأوا بأن هذا التقدم الحتمي سيولد عالماً مختلفاً كل الاختلاف بل مغايراً تماماً للعالم الذي كان أنه سيؤدي إليه، ولم يتوقع أي من هؤلاء، حتى ماركس نفسه الذي تكهن بثورة اجتماعية عام 1848 وخلال عقد من الزمان بعد ذلك، أن أي تغير فوري بالاتجاه المعاكس. بل إن توقعاته بدأت، بحلول الستينيات من ذلك القرن، تدور حول التطورات في المدى البعيد.
إن «دراما التقدم» هي استعارة بيانية. غير أنها كانت واقعاً حرفياً لدى فئتين من الناس، فقد كانت بالنسبة إلى ملايين الفقراء الذين نقلوا إلى عالم جديد، وعبر الحدود والمحيطات في أغلب الأحيان، تعني تغيراً جذرياً في الحياة وإلى شعوب العالم غير الرأسمالي، التي اكتسحتها هذه الدراما وهزت كيانها، فإنها كانت تعني الخيار بين مقاومة خاسرة ضد ما يهدد تقاليدها وسبل عيشها القديمة، والانخراط في عملية مؤلمة لاكتساب أسلحة الغرب ثم توجيهها ضد الغزاة، أي إما بفهم «التقدم» والتفاهم معه، أو بالتلاعب به، فقد كان الربع الثالث من القرن التاسع عشر يضم عالمين : واحداً للمنتصرين، وآخر للضحايا المهزومين. وكانت الدراما التي ينطوي عليها تشكل مأزقاً صعباً، لا للطرف الأول، بل للثاني في المقام الأول.
ليس بوسع المؤرخ أن يـكـون مـوضـوعياً إزاء الفترة التي تـشـكـل موضوع دراسته. وهو يختلف في ذلك (ولصالحه من الناحية الفكرية) عن الدعاة الأيديولوجيين المعتادين الذين كانوا يعتقدون أن تقدم التقانة ؛ أي «العلم الوضعي»، والمجتمع سيمكنهم من أن يدرسوا حاضرهم بحيدة منزهة على نحو ما يفعل العالم الطبيعي الذي يزعمون (خطأ) أنهم يفهمون منهجه. ولا يخفي مؤلف هذا الكتاب ما يحس به من الامتعاض، بل ربما بعض الازدراء، تجاه الموضوع الذي يدرسه، مع أن موقفه هذا ينطوي على قدر من الإعجاب بمنجزات ذلك العصر المادية الجبارة، مع محاولة من جانبه لفهم حتى ما لا يحبه. كما أن هذا المؤلف لا يخامره الـتـوق المشوق إلى اليقين، وإلى الثقة بالنفس اللذين تميز بهما عالم البورجوازية في أواسط القرن التاسع عشر، واللذان يغريان الكثيرين الذين يحنون إلى ذلك العالم عندما ينظرون إليه بعد قرن من الزمان من عالم الغرب الذي تتناوشه المآزق والأزمات. إن هذا المؤلف لا يخفي تعاطفه : أولئك الذين لم يلقوا مع آذانا صاغية إلا من قلة قليلة قبل قرن. لقد كان اليقين والثقة بالنفس كلاهما على خطأ على أي حال، فقد كان العالم البورجوازي غير دائم وقصير العمر. وفي اللحظة التي بدا فيها كاملاً مكتملاً، تبين أنه لم يكن متماسكاً، بل كانت تنخره الشقوق. وفي أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر، كان التوسع الاقتصادي والليبرالي أمراً لا يمكن مقاومته. غير أنه لم يعد كذلك مع نهاية ذلك العقد.
إن نقطة الانعطاف هذه تشكل نهاية الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب.
وخلافاً لعام 1848 الذي يمثل نقطة البداية، فإنها لا ترتبط بتاريخ محدد مناسب. وإذا اختبر مثل هذا التاريخ فإنه سيكون عام 1873 الذي يعادل ، في سياق المرحلة الفيكتورية، انهيار عام 1929 في وول ستريت، فقد بدأت في تلك السنة، بتعبير أحد المراقبين المعاصرين «حال في غاية الغرابة وغير مسبوقة من أكثر من ناحية، ساد فيها الاضطراب والكساد مجالات التجارة والمتاجرة والصناعة»، أسماها المعاصرون «الكساد الكبير»، الذي يؤرخ عادة في الفترة الممتدة بين عامي 1873 – 1896.
«إن الجانب البارز الأكثر غرابة في هذه الحال كما يقول هذا المراقب نفسه هو طابعها الشمولي؛ إذ إنها تركت آثارها في الدول التي شاركت بالحرب، وسلكت طريق السلام على حد سواء؛ وكانت لها عملات مستقرة … أو غير مستقرة …؛ وتلك التي تعيش في ظل نظام التبادل الحر للسلع، ويخضع فيها التبادل للقيود بصورة أو بأخرى. وكانت ثقيلة الوطأة على المجتمعات القديمة في إنجلترا وألمانيا، وباهظة كذلك على أستراليا، وجنوب أفريقيا، وكاليفورنيا التي تمثل مجتمعات جديدة؛ لقد كانت كارثة لم يكن ليتحمل أعباءها سكان نيوفوندلاند ولابرادور القاحلتين، ولا جزر الهند الشرقية والغربية المشمسة الزاخرة بالسكر والثمر؛ إنها لم تجلب الثراء لمن يعيشون في مراكز التبادل العالمية التي تصل فيها المكاسب في العادة إلى حدودها القصوى عندما تتولى التجارة أشد حالات التقلب والالتباس .
ذلك ما كتبه أمريكي شمالي مرموق في السنة نفسها التي أسست فيها، بتأثير من كارل ماركس، «الأممية العمالية الاشتراكية». لقد بدأ الكساد حقبة جديدة، ويمكن، على هذا الأساس، اعتباره خاتمة مناسبة للحقبة القديمة.







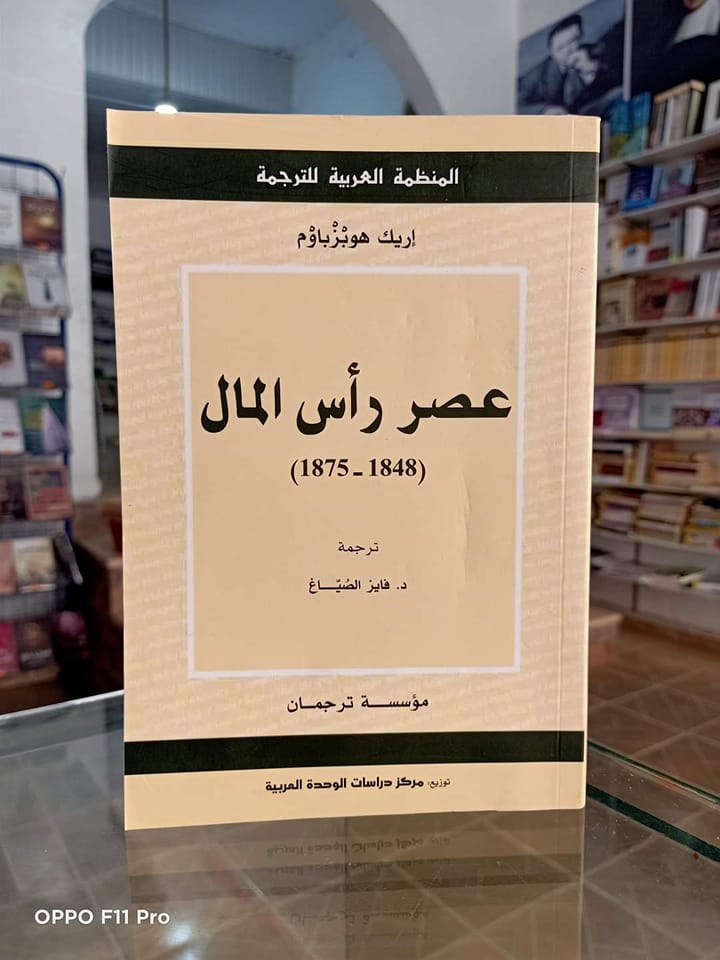

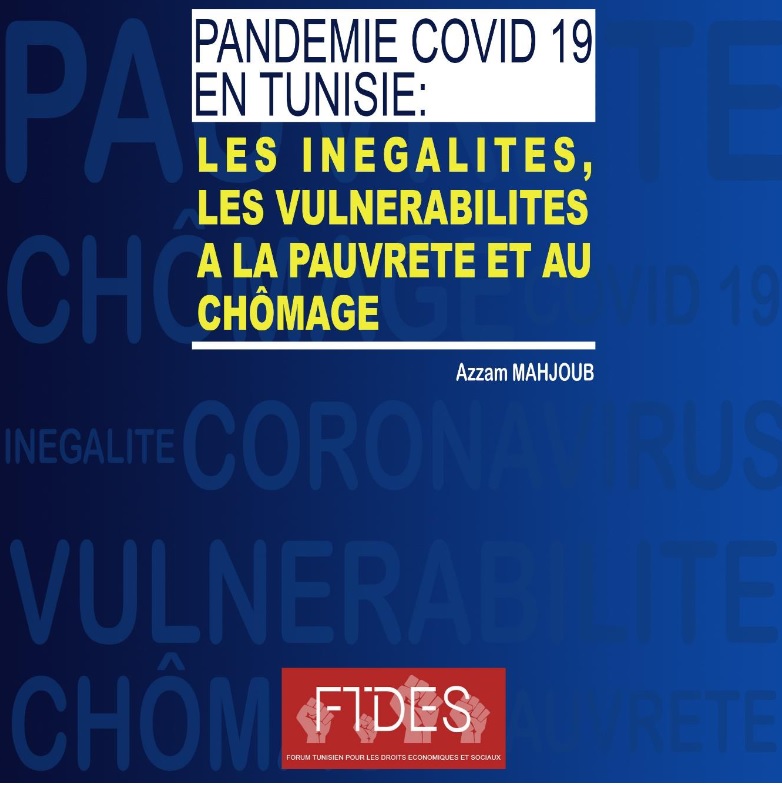
Comments