فورين أفارز: عام الفوضى في عهد ترامب .. الرئاسة غير المقيدة ونهاية الهيمنة الأمريكية
نشرت مجلة “فورين أفارز” مقالا مطولا بمناسبة مرور سنة على صعود الرئيس الأمريكي للحكم تحت عنوان: “عام الفوضى في عهد ترامب .. الرئاسة غير المقيدة ونهاية الهيمنة الأمريكية”، بقلم كل من دانيال دبليو. دريزنر وإليزابيث ن. سوندرز. من بين ما ركزا عليه التنبيه الى أن “”استخدام ترامب للجيش وقوات الأمن الفيدرالية لترسيخ سلطته الداخلية سيؤدي، على المدى البعيد، إلى تقويض القوة الأمريكية”..
في ما يلي ترجمة موسعة لأهم ما ورد في المقال
دانيال دبليو. دريزنر وإليزابيث ن. سوندرز
بالنسبة لمعظم الأميركيين والأوروبيين الأحياء اليوم، لم يكن عالم الفوضى يومًا واقعًا محسوسًا حقًا. فمنذ عام 1945، صاغت الولايات المتحدة وحلفاؤها نظامًا دوليًا وحافظوا عليه، نظامًا لم يكن ليبراليًا بالكامل ولا دوليًا خالصًا، لكنه أرسى قواعد حدّت من اندلاع الحروب بين القوى الكبرى، وروّج لعالم من التجارة المفتوحة نسبيًا، وسهّل أشكال التعاون الدولي. وفي العقود التي تلت ذلك، أصبح العالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أما قبل تلك المرحلة الطويلة من السلام بين القوى الكبرى، فلم تكن الفوضى أمرًا مجردًا في العالم المتقدم. فالنصف الأول من القرن العشرين وحده شهد حربين عالميتين، وكسادًا اقتصاديًا عالميًا، وجائحة قاتلة. وفي ظل ضعف القواعد العالمية وضعف آليات إنفاذها، لم يكن أمام معظم الدول خيار سوى الاعتماد على نفسها، وغالبًا ما لجأت إلى القوة العسكرية. ومع ذلك، كانت هناك حدود لما يمكن للدول ذات السيادة أن تفعله في سياق الصراع. إذ كانت الدول لا تزال في بدايات قدرتها على إسقاط القوة العسكرية خارج حدودها، كما أن حركة المعلومات والسلع والأشخاص كانت أبطأ بكثير. وحتى في فترات الاضطراب الدولي، لم يكن بوسع الدول أن تُلحق ببعضها البعض أذىً غير محدود دون أن تُعرّض نفسها للفناء.
اليوم، تقود الدولة الأقوى في العالم هذا النظام الدولي نحو نوع مختلف من الفوضى. فرغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن وحده المسؤول عن تراجع نظام ما بعد 1945، فإنه، خلال عامه الأول منذ عودته إلى الحكم، سرّع هذا التراجع بل واحتضنه صراحة. إن شهية ترامب للتوسع الإقليمي تقوّض أقوى قاعدة معيارية نشأت بعد 1945: وهي أن الحدود لا يجوز إعادة رسمها بالقوة المسلحة. كما أن استخفافه بالمؤسسات الداخلية أتاح له تجاوز أي محاولات داخلية للحد من تلك الطموحات التوسعية في الخارج.
الفوضى التي تتشكّل في ظل حكم ترامب، إذن، هي فوضى أكثر انفلاتًا. إنها أقرب إلى الفوضى البدائية التي وصفها الفيلسوف السياسي توماس هوبز—عالم «الكل ضد الكل»، حيث لا يمكن تحدي السلطة السيادية لا داخليًا ولا دوليًا. وفي هذا النظام الهوبزي، الذي يقوده زعيم يرفض أي قيود على قدرته على الفعل، ويستقوي بالتكنولوجيا التي تمكّنه من التحرك بسرعة إعصارية، يصبح كل شيء مباحًا. قد ينشأ نظام ما في نهاية المطاف من رحم هذه الفوضى، لكن من غير المرجح أن يكون هذا النظام بقيادة الولايات المتحدة—أو في صالحها.
العيش في العالم الحقيقي
لنبدأ أولًا بتحديد ما هي «الفوضى» (Anarchy) — وما الذي ليست عليه. يأخذ معظم الباحثين الواقعيين في حقل العلاقات الدولية الفوضى بوصفها نقطة الانطلاق الأساسية في نظرياتهم، كما تؤكد إدارة ترامب نفسها أن سياساتها تستند إلى فهم واقعي للعالم. ويعرّف الواقعيون الفوضى ببساطة على أنها غياب سلطة عليا في النظام الدولي. ففي ظل عدم وجود جهة تفرض قواعد اللعبة العالمية، لا يكون أمام الدول سوى الاعتماد على قوتها الذاتية واستراتيجياتها الخاصة من أجل البقاء. وكما عبّر عالم السياسة كينيث والتز، فإن النظام الدولي هو نظام «المساعدة الذاتية» (Self-Help). وفي عالم تسوده الفوضى، تصبح الحرب جزءًا طبيعيًا من العلاقات الدولية.
غير أن الفوضى لا تعني الفوضى العارمة أو الانهيار الشامل. إذ يرى الواقعيون أن غياب السلطة المركزية لا يعني بالضرورة اضطرابًا دائمًا في النظام الدولي. بل إن الفوضى نفسها تعمل بوصفها قيدًا قويًا، إذ تُجبر الدول على التصرف بحذر وترشيد مواردها. كما أن خطر الحرب قد يدفع حتى القوى الكبرى إلى التريث قبل الإقدام على سياسات عدوانية، تفاديًا لإثارة تحالفات موازِنة ضدها. وفي هذا السياق، يجادل عالم السياسة الواقعي تشارلز غلاسر بأن هذا المنظور ليس بالضرورة تشاؤميًا، وأن الدول يمكنها ممارسة «المساعدة الذاتية» عبر التعاون.
وعليه، يؤمن الواقعيون بإمكانية تحقق النظام والاستقرار حتى في عالم فوضوي. بل إنهم، رغم استمرار خلافاتهم حول ما يعنيه انتهاج سياسة خارجية واقعية، يتفقون على أن الفوضى لا ينبغي أن تعني التخلي عن الاستراتيجية، ولا اغتنام كل فرصة لخوض الحروب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
الفوضى لا تعني الاضطراب أو الانهيار
تقوم إحدى أكثر النظريات تأثيرًا في تفسير كيفية نشوء النظام من رحم الفوضى على ما يُعرف بـنظرية الاستقرار الهيمني، وهي الفكرة القائلة إن النظام الدولي يكون أكثر استقرارًا عندما تهيمن عليه دولة واحدة. وقد جادل عالم السياسة روبرت غيلبين بأن الدولة المهيمنة توفّر «سلعًا عامة دولية» مثل المؤسسات النقدية أو التحالفات الأمنية، وتضع القواعد وتفرضها (وغالبًا ما تكون هذه القواعد في مصلحتها)، كما تُيسّر التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي. ووفقًا لغيلبين، فإن مثل هذه الأنظمة الهيمنية تنشأ عادةً عقب حروب كبرى، لكنها تكون محكومة في النهاية بالأفول، حين تُرهق الدولة المهيمنة نفسها بالتوسع المفرط، وتبرز قوى صاعدة تنافسها على الزعامة العالمية.
للوهلة الأولى، يبدو هذا السرد وكأنه يصف اللحظة الراهنة بدقة. إذ يمكن القول إن الولايات المتحدة بلغت ما سمّاه المؤرخ بول كينيدي «التمدد الإمبراطوري المفرط» منذ وقت طويل، أي قبل ترامب بسنوات. فقد أنهكت الحربان المكلفتان والفاشلتان في أفغانستان والعراق القدرات العسكرية الأميركية إلى حدودها القصوى. وفي المقابل، برزت الصين كقوة صاعدة تتحدى الولايات المتحدة على مستوى القيادة العالمية، والتفوّق التكنولوجي، والهيمنة الاقتصادية. ووفق هذا المنظور، فإن الخيار الأفضل لواشنطن يتمثل في ترشيد مواردها، والحفاظ على شبكة تحالفاتها وشراكاتها، والاستعداد لاحتمال الصدام مع المنافس الصاعد.
وبالفعل، اعتقد كثير من المراقبين أن إدارة ترامب ستعيد توجيه بوصلتها نحو الصين، بما في ذلك سحب جزء من الموارد الأميركية من أوروبا والشرق الأوسط. ورغم أن ترامب لم يرث بيئة دولية هادئة، فإنه كان لا يزال يملك هامشًا للتحرك: فعلى الرغم من اندلاع حروب في أوكرانيا وغزة والسودان، لم تنفجر حرب عالمية شاملة، وكانت لواشنطن شراكات قوية في أوروبا مكّنتها من مساعدة القارة على كبح روسيا، التي تُعد أقرب مثال على قوة عظمى «مراجِعة» تسعى إلى تغيير النظام القائم، ومنعها من السيطرة على أوكرانيا عقب غزوها الشامل عام 2022. كما كانت الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بشبكة تحالفات واسعة، وجهاز دبلوماسي كفء ومتشعب، وأقوى قاعدة بحث علمي في العالم.
غير أن ترامب، خلال عام واحد فقط، قوّض معظم هذه المزايا، إمّا بتفريغها من مضمونها أو بالتخلي عنها، على الرغم من قيمتها الاستراتيجية في سياق التنافس على الهيمنة بين القوى الكبرى. وبدلًا من ذلك، تبنّى نهجًا قائمًا على الاستخلاص، والفساد، وترتيبات تعاملية ظرفية يمكنه نقضها أو تعديلها في أي وقت.
نظرية اللّاستقرار الهيمني (Hegemonic Instability Theory
على مدى العام الماضي، أوقف ترامب الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما تبقّى من النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، وخاض معارك غير ضرورية ومتزايدة الخطورة مع حلفاء أساسيين، وقوّض الأسس نفسها التي تقوم عليها القوة الأميركية. فحرب روسيا في أوكرانيا، التي يبدو أن ترامب لا يبدي إزاءها اهتمامًا يُذكر، والمنافسة مع الصين، التي يكاد يغيب ذكرها عن أحدث استراتيجية للأمن القومي لإدارة ترامب، تمثلان أخطر التهديدات للنظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة. ومع ذلك، نجد الجيش الأميركي يحشد قواته في منطقة الكاريبي، وينقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى البحر المتوسط على خلفية احتجاجات في إيران. كما أن تهديدات ترامب لسيادة غرينلاند والدنمارك — وما تنطوي عليه من استعداد واضح لنسف حلف شمال الأطلسي (الناتو) — قد أدّت بلا داعٍ إلى استفزاز الدول الأوروبية، التي كانت في الأصل مستعدة لمنح واشنطن مستوى من النفاذ لا تحظى به إلا قلّة من الدول في العالم.
والنتيجة هي قوة مهيمنة آخذة في التراجع، لا تسعى إلى الحفاظ على موقعها، بل تتحول إلى قوة «مراجِعة» للنظام القائم. فالولايات المتحدة تضخّ قدرًا متزايدًا من العدوانية في النظام الدولي، وكأن ذلك غاية في حدّ ذاته، في الوقت الذي تقلّص فيه القدرات التي ساهمت أصلًا في إنشاء النظام الذي استفادت منه والحفاظ عليه. وكما جادلت أونا هاثاواي وسكوت شابيرو في مجلة فورين أفيرز، فإن ترامب يخلق عالمًا «لا تكون فيه القواعد غير قابلة للتنبؤ فحسب، بل تصبح أيضًا رهينة اندفاعات من يمتلك في لحظة معيّنة أكبر قدر من القوة القسرية”.
العالم الذي يصنعه ترامب ليس ذلك النوع من الفوضى الذي يتحدث عنه الواقعيون المعاصرون، حيث تُجبَر الدول على اتخاذ قرارات رشيدة بشأن متى وأين تتحرك، ومع من وضد من تتحالف، وكيف — وبأي قدر — تفرض إرادتها على الآخرين. ففي ذلك العالم، يظلّ النظام ممكنًا. أمّا ترامب، وعلى النقيض من ذلك، فيتخذ قرارات مصيرية من دون إجراءات مؤسسية واضحة، وفي أوقات تبدو عشوائية، ومن دون أن تفرضها حالات طوارئ فعلية. ومن خلال الاستحواذ على أدوات الهيمنة، يتصرّف ترامب بعدوانية في مناطق متعددة في الوقت نفسه، وبوتيرة لم يكن في وسع أي قوة عظمى سابقة أن تتصورها. ففي غضون أسبوع واحد فقط من شهر يناير، نفّذت إدارة ترامب مهمة عسكرية في كراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووجّهت تهديدات إلى حلفائها في الناتو بشأن الاستيلاء على غرينلاند، وعزّزت في الوقت نفسه انتشار عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس رغم الاحتجاجات الواسعة.
لم يمتلك أيّ قوّة مهيمنة في التاريخ قدرات إسقاط القوة التي ما تزال الولايات المتحدة تتمتع بها، ولا سرعة التواصل واتساع نطاقه التي أتاحها العصر الرقمي. ففي الشهر المقبل، قد يكون من المحتمل بالقدر نفسه أن يقرّر ترامب قصف إيران مجددًا، أو أن يعقد صفقة مع رجال الدين الحاكمين في إيران للحصول على تنازلات نفطية. وربما يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو — على العكس تمامًا — يقدم على غزو غرينلاند.
وإذا كان لعدم القدرة على التنبؤ أي قيمة بوصفه تكتيكًا جيوسياسيًا، فينبغي استخدامه على نحو استراتيجي ومدروس وبحدود ضيقة. أمّا نزوات ترامب المتقلّبة، التي يستطيع أن يترجمها إلى أفعال أسرع وأسهل من أي قائد في التاريخ، فإنها تمثّل مستوى جديدًا من الفوضى
بناء الوحش السياسي
تختلف الفوضى الترامبية الجديدة في جانب مهم آخر: فلم يحدث في أي مرحلة من التاريخ أن بدأت قوة مهيمنة، كانت لقرون طويلة ديمقراطية مترسخة (وإن لم تكن كاملة)، في التراجع الديمقراطي وتفكيك مؤسساتها بهذه السرعة. فالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، تراجعت عن موقعها كقوة عظمى بينما كانت تصبح أكثر ديمقراطية في القرن التاسع عشر، لا أقل. أما اليوم، فإن الولايات المتحدة تمزّق القواعد الدولية القديمة وتحاول هدم قيودها المؤسسية الداخلية وأسس قوتها خلال عام واحد مذهل السرعة.
من هذه الزاوية، تقترب رؤية ترامب للعالم من فهم هوبز للفوضى أكثر مما تقترب من فهم الواقعيين. ورغم أن معظم الواقعيين يعدّون هوبز جزءًا من تقاليدهم الفكرية، فإن تصوّره للنظام كان يمتدّ أعمق بكثير إلى المجال الداخلي مما يرغب معظم الواقعيين في الذهاب إليه. فقد وصف الفوضى الشهيرة بوصفها حرب «الكل ضد الكل»، حيث تكون الحياة «قذرة، ووحشية، وقصيرة». والأقل شهرة هو اعتقاده بأن بقاء الكومنولث في عالم بهذه القسوة يقتضي أن يكون السيّد (الحاكم) قادرًا على ممارسة سلطة شبه غير مقيّدة في الداخل. وكان هوبز يزدري أي فصل للسلطات أو أي تكتّل داخلي للقوة خارج شخص السيّد نفسه.
في السنة الأولى من ولايته الثانية، سعى ترامب إلى تركيز السلطة على المستويين الدولي والداخلي معًا. فعلى الصعيد الدولي، أوضح أنه لا يرى نفسه مقيّدًا بأي شكل من أشكال القانون أو الأعراف الدولية. وفي مقابلة مع نيويورك تايمز، أعلن أن أخلاقياته الشخصية هي القيد الوحيد على أفعاله. وقال للصحفيين: «لا أحتاج إلى القانون الدولي». وقد تصرّفت إدارته على هذا الأساس. فبعد وقت قصير من تثبيته، أقال وزير الدفاع بيت هيغسيث كبار محامي الجيش، في إشارة واضحة إلى اعتقاده بأن القيود القانونية على خوض الحروب تُعدّ عائقًا أمام القوة الأمريكية. ويواجه هيغسيث اليوم اتهامات بانتهاك القانون الدولي عقب الضربات الأمريكية على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في الكاريبي، وكذلك العملية التي استهدفت إزاحة مادورو في فنزويلا.
كما اتخذ ترامب خطوات لإزالة القيود الداخلية على سلطته. ففي ولايته الأولى، كان يتضايق من عدد من السدود المؤسسية التي كبحَت اندفاعاته وتفضيلاته السياسية: الكونغرس، والسلطة القضائية، وحتى ما سُمّي بـ«العقلاء في الغرفة» داخل إدارته نفسها. أما في ولايته الثانية، فقد تجاهل أو تجاوز أو دهس أي قيود قانونية أو مؤسسية. ومع ضعف يُذكر في معارضة الكونغرس أو المحكمة العليا، أعلن عشر حالات طوارئ مختلفة خلال عامه الأول في قضايا تتراوح بين الطاقة والهجرة والمحكمة الجنائية الدولية، وهي إجراءات تعزّز سلطة السلطة التنفيذية. وفرض نظام تعريفات جمركية مشكوكًا في دستوريته في محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإعادة بناء قطاع التصنيع الأمريكي. ونشر ضباطًا فدراليين وقوات من الحرس الوطني في مدنٍ رغم اعتراض القادة المحليين، لتسريع حملته للترحيل الجماعي. وأقال—وحاول إقالة—مسؤولين في السلطة التنفيذية كان يُعتقد سابقًا أنهم مستقلون عن الامتيازات الرئاسية. وسلّح وزارة العدل لملاحقة ثأراته السياسية. كما اعتدى على أسس القوة الوطنية عبر تقليص تمويل البحث العلمي والخبرة الدبلوماسية.
في شهر يونيو/حزيران، جادل أحدنا (سوندرز) في مجلة فورين أفيرز بأن الولايات المتحدة باتت تنتهج سياسة خارجية أقرب إلى سياسة ديكتاتورية شخصانية. واليوم، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، يتصرف رئيس الولايات المتحدة مع قدر ضئيل من القيود. وقد وجد سكان الولايات المتحدة أنفسهم الآن خاضعين للفوضى الهوبزية نفسها التي أطلقها ترامب على بقية العالم.
صحيح أن القضاة وهيئات المحلفين والمواطنين يبدون مقاومة، وقد ينجحون في نهاية المطاف في حرمان ترامب من الأوتوقراطية المُمركزة التي يبدو أنه يسعى إليها. غير أن إعادة بناء الثقة في المؤسسات الأمريكية على المستوى الداخلي—فضلًا عن المستوى الدولي—ستكون عملية صعبة وطويلة الأمد
قذِر، وحشي، وقصير النظر
يرى عالم السياسة ألكسندر وندت أن «الفوضى هي ما تصنعه الدول منها». وقد استغلت إدارة ترامب السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة، التي ما تزال القوة المهيمنة عالميًا، لصياغة نسخة من الفوضى ذات طابع هوبزي خالص. وقد أطلقت على استراتيجيتها شعار «السلام عبر القوة»، وأعلنت تبنّي سياسة خارجية تقوم على «الواقعية المرِنة»، التي يفهم واضعوها أنها تعني «الواقعية في تقدير ما هو ممكن ومرغوب في السعي إليه في التعامل مع الدول الأخرى”.
أنصار ترامب سيجادلون بأن هذا النهج عزّز الهيمنة الأمريكية. وبالفعل، من خلال تحركاته الهوسية حول العالم، سلّط ترامب الضوء على مجمل المزايا التي راكمتها الولايات المتحدة على امتداد «القرن الأمريكي». غير أن إدارته تستخدم هذه المزايا على نحو لا ينصح به أي واقعي.
إن أسس القوة الأمريكية متجذّرة في سيادة القانون داخليًا وفي الالتزام الموثوق به خارجيًا، وهما بالذات الأمران اللذان سعى ترامب إلى تقويضهما. فتجفيفه للمساعدات الخارجية، وتفكيكه للبنية التحتية التي تقوم عليها الهيمنة العلمية والتكنولوجية الأمريكية، ومواجهته الخطِرة مع الحلفاء الأوروبيين الراسخين، والأشد ضررًا من كل ذلك استخدامه للجيش وأجهزة الأمن الفيدرالية لترسيخ سلطته داخليًا—كلها سياسات ستقوّض، على المدى الطويل، القوة الأمريكية.
لقد بدأ الحلفاء الذين أُبعدوا بالفعل في مدّ الجسور مع الصين ومع بعضهم البعض تحسّبًا لولايات متحدة متقلّبة وغير قابلة للتنبؤ. وسواء نجحت هذه السياسات أم لا، فإنها تُضعف الولايات المتحدة وتجعل الصين أكثر جاذبية نسبيًا للدول الصغيرة الباحثة عن الأمن. وفي النظام العالمي الصفري الذي يتصوّره ترامب، ستكون الولايات المتحدة هي من يدفع الثمن في نهاية المطاف.
كاتبا المقال:
**/ دانيال دبليو. دريزنر هو العميد الأكاديمي والأستاذ المتميز في السياسة الدولية بكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، ومؤلف النشرة الإخبارية “عالم دريزنر”.
**/ إليزابيث ن. سوندرز هي أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، وزميلة أولى غير مقيمة في معهد بروكينغز، ومؤلفة كتاب “لعبة المطلعين: كيف تصنع النخب الحرب والسلام”.
الرابط الأصلي:









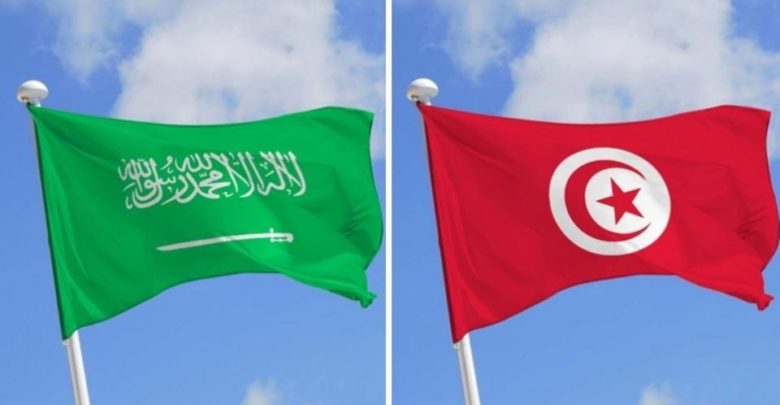
Comments