بريطانيا تدير ظهرها إلى الحضن الأوروبي.. سيرورة تاريخية نحو المجهول
بقلم محمد بشير ساسي
قد يُقرأ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاما – في نطاق إجرائي – إيفاءا لوعد قطعه رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، بعد فترة دراميّة حرجة عاشتها المملكة المتحدة منذ استفتاء الخروج عام 2016، وما أفرزه من أسوأ حالة انقسام واستقطاب سياسيين في تاريخها الحديث..
وقد تنحصر المسألة في أذهان كثيرين ممّن غنوا « ليحمي الله الملكة » احتفالا باستعادة استقلالهم، على اعتبار أن الحدث كان بمثابة الإستجابة للّحظة التي ينبلج فيها الفجر وتفتح خلالها صفحة جديدة من تاريخ بريطانيا التواقة إلى مسيرة وطنية كبرى من التجديد والتغيير كما يروج لها قادة حملة « المغادرة » منذ سنوات.
فمسار الطلاق » بالخطوة الجيوسياسية في بريطانيا منذ خسارتها إمبراطوريتها، حيث يتردد بين الأوساط المؤمنة بالإنفصال أنه من حقّ بلدهم أن يحدد كما يشاء مسار الأجيال القادمة … كما وجد »البريكسيت » صدى إشادة حتى من خارج بريطانيا وتحديدا من قبل زعيمة « التجمع الوطني » اليميني الفرنسي مارين لوبان،التي اعتبرته « عودة الحرية » لبريطانيا التي فعلت الصواب، ومن المرجح أن يعود عليها ذلك بمنافع كبرى، وهو يعكس برأيها فشلا ذريعا للاتحاد الأوروبي » الذي يجب أن « يتحوّل إلى تحالف بين الأمم الأوروبية على حد إعتقادها.
لكن وسط كل هذه النشوة الهستيرية و الإحتفالات بالخروج بعد مفاوضات صعبة، ثمة من يطرح الموضوع طرحا بعيدا عن المقولات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة،وهو طرح دفع البعض إلى البكاء بحرقة على الطعنة التي تلقها الجسم الأوروبي بعد إصرار بريطانيا على إدارة ظهرها إلى الحضن الذي رعاها منذ الأول من يناير/كانون الثاني عام 1973 لتقوية مشروع الوحدة الأوروبيّة على أنقاض الحرب العالمية الثانية التي دمرت القارة العجوز مخلفة الكثير من الكراهية والأحقاد بين الشعوب.
فالمسألة يبدو أنها أعمق بكثير من الرمزية في إنزال علم الاتحاد الأوروبي من خارج السفارة البريطانية في بروكسيل أو إزالة العلم البريطاني من على مبنى المجلس الأوروبي ليتم وضعه مع أعلام الدول غير الأعضاء..
الحدث وإن كان منتظرا إلا أنه شكل ضربة قوية ومؤلمة للجميع مثلما عبرت عن ذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركــــــــــــــــل، في حين اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون إشارة إنذار تاريخية يجب سماعها، مضيفا أن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انطلقت عام 2016، كانت قائمة على « الأكاذيب والمبالغة والتبسيط »، داعيا الأعضاء الآخرين في الاتحاد إلى عدم نسيان « ما يمكن أن تؤدي إليه الأكاذيب في الديمقراطيات.
أما ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين حول البريكست الذي بات مكلفا بالمباحثات حول العلاقة المستقبلية مع لندن « فقد عبر عن أسف لاختيار بريطانيا الانعزال بدل التضامن مؤكدا أنّ هذا الخيار سيسهم في إضعاف الجانبين.
فمشروع المؤسسين الأوائل، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان والمستشار الألماني كونراد أديناور ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرتشل كان يُنظر إليه أرقى تجربة حضارية جوهرها الأساسي بناء سلام راسخ قوامه الحرية وحقوق الإنسان، قبل المنافع الإقتصادية والمالية.
بيد أنه في سياق الإنفصال يبدو الأمر بات بمثابة إعادة النبش في الجروح العميقة داخل الاتحاد، بل وداخل بريطانيا نفسها، وربما ينظر إليها المؤرخون مستقبلا على أنها بداية تراجع مكانة أوروبا حضاريا وانتقال مراكز القوة ومحورية العالم من الغرب إلى الشرق والمقصود بها (آسيا).
قبل الوصول إلى هذا المنعطف الكبير، كانت أوروبا تعلم جيدا أنها تحمل في رحمها أجنة التفكك وحمى الانفصال، فالخطورة الحقيقية التي يمثلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تتمثل في كونه أشبه بـ«العدوى»، التي ربما تنتقل من دولة إلى أخرى داخل القارة العجوز، في ظل العديد من المعطيات، وعلى رأسها صعود التيارات اليمينية، والمعروفة بنزعتها الوطنية، وبالتالي عدم اعترافها بالسياسات «العابرة للحدود»، على اعتبار أنها تنتقص كثيرا من سيادة الدول، وهو الأمر الذي يمثل تهديدا صريحا لبقاء أوروبا الموحدة، في ظل تنافر مبادئها الليبرالية، مع توجهات الزعماء الجدد لدول القارة.
ولعل النموذج الكاتالوني هو الأكثر بروزا فيما يتعلق بمفهوم الانفصال، حيث شهدت المدن الكاتالونية حالة من الفوضى، تثور بين الحين والآخر، منذ الدعوة إلى استفتاء على برعاية الحكومة الانفصالية، في عام 2017، إلا أنه لم يكتمل بسبب تدخل السلطات الإسبانية بالقوة لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
لكن يبقى حتى هذه اللحظة وقْع الزلزال البريطاني أثقل من غيره، كون التاج نفسه، يحمل بذور التفكك أكثر من غيره، فإسكتلندا ترغب مثلا في إجراء استفتاء بشأن الاستقلال من المملكة المتحدة وذلك رغبة منها في البقاء وفق الإشارات التي بعثت بها زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورغن والتي تترأس أيضا منصب الوزير الأول في إسكتلندا ، حيث تعهدت في كلمة لها أمام حشد من أنصارها، ببناء « أمل في مستقبل أفضل، وأفضل لإسكتلندا ».
الشيء نفسه يقال عن منطقة إيرلندا الشمالية، حيث أذكى البريكست فكرة الوحدة الإيرلندية وذلك أيضا للبقاء في صفوف الاتحاد الأوروبي.
غير أن لندن وبمعنى أدق حكومة المحافظ الوزراء بوريس جونسون وفي ظل الدعم والتأييد الذي تتلقاهما من وراء المحيط وتحديدا من قبل واشنطن الطامحة بدورها لإخراج حليفتها الأزلية من « طغيان بروكسل » كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن ذلك لا يعني أن بريطانيا انسلخت نهائيا من جلدها الأوروبي وارتمت في أحضان الولايات المتحدة ودونالد ترامب.
فزعيم المعارضة جيرمي كوربن، سرعان ما أطلق وعيده بمحاسبة الحكومة على كل خطوة تقوم بها في إطار مناقشة القضايا العالقة وحماية والوظائف ومعايير العيش من أجل ضمان حقوق الجميع، كما طالب كوربن بــــ »بريطانيا أممية حقّاً، متنوّعة، منفتحة على الخارج وتتمتع بعلاقة تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي.
خلاصة القول إذا كان سرّ عودة بريطانيا إلى زمنها الإمبراطوري يكمن في «إرادة الانفصال» وتبني مفهوم « الدولة القومية»، فمن يضمن عدم المساس بمبدأ إرادة العيش المشترك بعيدا عن الفوضى والهلع ؟ أم أنّ الخروج من الفضاء الأوروبي سيرورة تاريخية لابد منها ، تبيحها إدارة ومسؤولية الشعب البريطاني بما تحمل الخطوة من مخاوف وضباية بشأن مستقبل يمكن أن يضعف فيه الغرب، وينسف خلاله ما تبقى من النفوذ العالمي لبريطانيا، وتقوّض اقتصادها لتتحول في الأخير إلى مجموعة من الجزر المنعزلة في شمال المحيط الأطلسي؟
كاتب وإعلامي تونسي









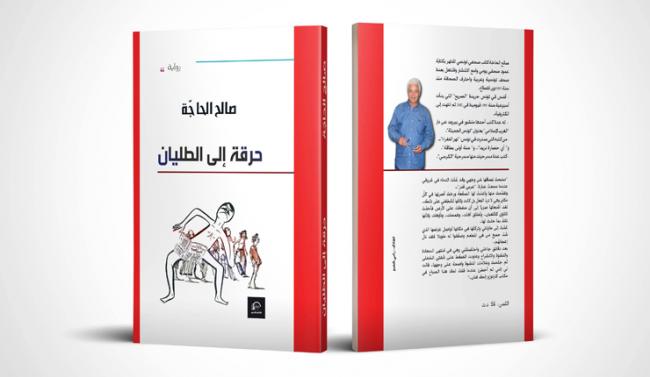
Comments